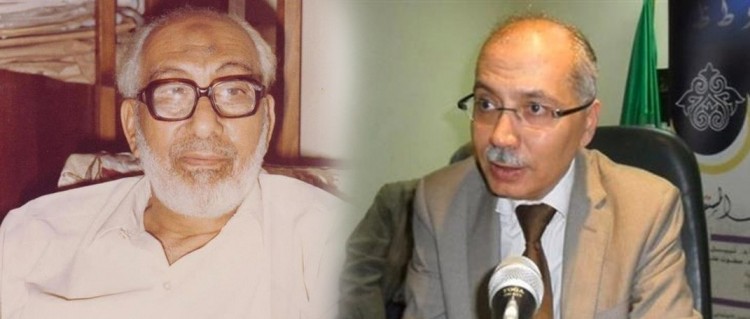كنت ÙÙŠ الØادية عشرة من عمري عندما قامت ثورة يوليو، وبعد شهور من نجاØها كان قائدها ÙÙŠ ذلك الوقت Ù…Øمد نجيب يزور بعض الأقاليم، وقال أبي أمامي ليسمعني: إنه قرأ ÙÙŠ Ø¥Øدى الجرائد أن صبيًا ÙÙŠ الØادية عشرة ألقى أمام Ù…Øمد نجيب قصيدة Øياه بها، وأبدى والدي-رØمه الله- إعجابًا شديدًا بهذا الصبي الذي ÙÙŠ مثل سني، وكانت هذه طريقته عندما يريد أن يوجهني إلى شيء أو ÙŠØÙزني عليه. وقد قيل: أيامها إنّ Ù…Øمد نجيب سو٠يزور Ø¥Øدى القرى التابعة لشبين الكوم بالمنوÙية، وسو٠يذهب إليها عن طريق الباجور وهو الطريق الذي يمرّ على قريتنا، وقيل: إنه سو٠يتوق٠قليلا عند قريتنا. ÙÙ‚Ùز إلى ذهني ذلك الصبي الذي استأثر بإعجاب والدي، ÙˆÙكرت أن أصنع صنيعه، وأنال شيئًا من إعجاب أبي وأÙقر عينَه بي.
وأذكر أنني عكÙت يومًا أو يومين على كتابة (قصيدة) Ø£Øيي بها قائد الثورة عندما يتوق٠عند قريتنا، ولم يكن ÙÙŠ ذهني من مثال للشعر الذي أريد أن أكتبه إلا الأناشيد التي كنا Ù†ØÙظها ÙÙŠ المدرسة الإلزامية، ولم يكن ÙÙŠ مخزوني اللغوي إلا القرآن الكريم الذي كنت أتممت ØÙظه قبل ذلك بعام، ولذلك جاء ما كتبته آنذاك بعض Ù†ØµØ§Ø¦Ø Ù„Ù‚Ø§Ø¦Ø¯ الثورة، وبعض سباب٠للعهد الملكي ÙÙŠ كلام أظهر ما Ùيه السجع وبعض العبارات المنقولة بنصها من القرآن الكريم. ثم سارعت Ùأعطيت ما كتبت لأبي، ÙˆØظيت منه بابتسامة صامتة لم أستطع أن أميز وقتها أهي ابتسامة إعجاب أو أنها يمازجها شيء من الإشÙاق؟ من هذا التاريخ البعيد بدأ خيالي الصغير ÙŠÙشغل بهذا الشيء الذي يسمّى الشعر، وبدأت أكثر من الهذرÙØ© والمØاولة والتقليد. وقد أكسبتني هذه المØاولات المبكرة التعلق بالشعر، ÙˆØبه، والقدرة على الØÙظ والاستجابة للنغم الكلامي. ألØقني أبي – الذي كان قد نذرني للأزهر الشري٠– بعد ذلك بمعهد القاهرة الديني، ووجدتني مع زملائي أدرس الÙقه والنØÙˆ والتوØيد والØساب والجغراÙيا والسيرة النبوية وسيرة الخلÙاء الراشدين، ولم يكن للشعر نصيب إلا Øصة المØÙوظات التي لم تكن تØظى لدى الأساتذة والطلاب معًا بشيء من الاهتمام، وكان يكÙÙŠ الطالب أن ÙŠØÙظ بعض الأبيات يلقيها أمام لجنة الامتØان الشÙوي آخر العام. وكان هذا الامتØان Ù†Ùسه لا يظÙر بالاهتمام الواجب؛ إذ كان التركيز Ùيه منصبًّا – إن وجد – على ØÙظ القرآن الكريم، Ùقرّ ÙÙŠ Ù†Ùسي من أول عام لي ÙÙŠ الأزهر أن سبيل الشعر إمّا كنت٠سالكَه عليَّ أن أسلكه ÙˆØدي.
بعد أن أديت امتØان السنة الأولى الابتدائية بمعهد القاهرة الديني زرت ÙÙŠ طريق عودتي إلى القرية ابن عمتي الأستاذ عبد الباري خطاب – عليه رØمة الله – وكان مدرسًا للغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وهو Ø£Øد خريجي كلية اللغة العربية بالأزهر، وكان خطيبًا شاعرًا، Ùقدم لي كتابين قيمين نصØني أن أقرأهما ÙÙŠ الإجازة الصيÙية، أولهما كتاب (المنتخب من أدب العرب) وهو من خمسة أجزاء، ألÙÙ‡ طه Øسين وأربعة معه، والآخر كتاب (التوجيه الأدبي) لمؤلÙÙŠ المنتخب أنÙسهم. وجدت ÙÙŠ كتاب المنتخب اختيارًا لشعراء العربية بدءًا من امرئ القيس ÙÙŠ العصر الجاهلي وما بعده ÙÙŠ العصور الأدبية المتوالية Øتى العصر الØديث. Ùأقبلت على القصائد المختارة أقرأ، وأØÙظ منها ما Ø£ØÙظ، وأباهي أقراني وزملائي بما Ø£ØÙظه، وما Ø£Øصله من Ù…Ùردات جديدة لا عهد لهم بها. ومن خلال كتاب (التوجيه الأدبي) Øصلت شيئًا من تاريخ الأدب ونقده، وطرÙًا من الأجناس الأدبية الأخرى، وتعريÙًا بها بدءًا من المرØلة اليونانية، وانتهاء بالعصر الأوروبي الØديث. وكان هذا بابا لمجال واسع عليّ ÙÙŠ ذلك الوقت المبكر. وكلما Øصلت شيئًا ÙÙŠ هذا الميدان أدركت أن الشوط طويل وأن المدى واسع وأنني تائه غريب، وأØسست أيضًا بضرب من التÙرد بين زملائي مما جعلني أشعر بالاغتراب؛ إذْ لم يكن Ø£Øد ممن أعر٠ÙÙŠ هذه المرØلة يهتم بمثل ما أهتم به، ويØاول مع الشعر شيئًا مما Ø£Øاول.
ÙÙŠ الرابعة عشرة من العمر، وكنت ما أزال ÙÙŠ المرØلة الابتدائية، وقعت ÙÙŠ (الØب) وبطبيعة الØال كان Øب المراهقة، وكانت Ø¥Øدى جارات بيتنا ÙÙŠ القرية، وكانت تكبرني بعام، وكانت أكثر نضجًا مني. وكانت كلمة (الØب) Ù†Ùسها ÙÙŠ قريتي مما يعاب ÙÙŠ هذا الزمن أي ÙÙŠ الخمسينيات من القرن الماضي. وكم Ø£Øسّ بالدهشة والØسرة على أبناء جيلي عندما أذهب إلى قريتي الآن ويدور Øديث مألو٠غير منكور عن أن Ùلانًا (ÙŠØب) Ùلانة، أو أن Ùلانة (تØب) Ùلانًا. ويÙيض بقلبي الألم على ما Øدث لي ÙÙŠ ذلك الزمن الغابر الذي كان المرء يشعر Ùيه بخزي شديد إذا أذيع سرّ Øبه. كنت Ø£Øس ÙÙŠ ذلك الوقت أني Ø£Øمل بين جنبي سرّا خطيرًا من أسرار الكون، وبقدر ما كنت أشعر بالسعادة الغامرة أن اختارتني المقادير لهذا الØب كنت Ø£Øسّ بالرثاء لنÙسي مما أعانيه من كتمان، وبدوت بيني وبين Ù†Ùسي رومانسيًّا Øالمًا، وكنت أعزي النÙس بأن هذا من قدر (الشعراء)ØŒ ووجدت ÙÙŠ Ù…Øاولاتي الشعرية متنÙَّسًا Ø£Ùضي Ùيها بذات Ù†Ùسي ÙˆØ£Ø¨ÙˆØ Ø¨Ù…Ø§ ينوء به القلب المكلوم. ومَثّل لي الØب ÙÙŠ هذه المرØلة راÙدًا كنت أراه ضروريًا من رواÙد الشعر وداÙعًا من دواÙعه، وكم رأيت Ù†Ùسي ÙÙŠ بعض الشعراء العذريين، وكنت لا أستطيع أن أكÙÙƒÙ Ù†Ùسي عندما كانت عيناي تغرق بالدمع، ويشرق به Øلقي لقراءة قصيدة من قصائد مجنون ليلى أو جميل بثينة، ولعل Ùتنتي بمسرØية مجنون ليلى لأØمد شوقي ÙÙŠ هذه المرØلة كانت بسبب أني خيّلت لي Ù†Ùسي أني أنا (المجنون). ولي مع مسرØية Ø£Øمد شوقي (مجنون ليلى) قصة Ùيها من الطراÙØ© طرÙØŒ ذلك أني كنت ÙÙŠ الرابعة الابتدائية، وكنت جالسًا ÙÙŠ الÙصل أقرأ هذه المسرØية وقد وضعت يدي بها أسÙÙ„ درج المقعد الذي أجلس عليه، ودخل مدرس Øصة المØÙوظات الذي كان يدخل الÙصل علينا لأول مرة بعد مرور أكثر من نص٠العام، إذ كان ذلك ÙÙŠ أواخر Ùبراير سنة 1958Ù… ولم أشعر به لأني كنت مندمجًا مع المشهد الذي يبكي Ùيه مجنون ليلى على قبرها اندماجًا كاملا، وطلب المدرس من الطلاب أن يخرجوا كراسات المØÙوظات ليملي عليهم قصيدة يكتبونها، ولم أستجب للطلب لأني لست معه، Ùأتى إليّ متمهلا، وأنا لا أشعر به، ووجد ÙÙŠ يدي المسرØية Ùأخذها مني – وكنت استعرتها من Ø£Øد الطلاب الذين يسبقونني – ولما لم تكن معي كراسة للمØÙوظات وبَّخني توبيخًا شديدًا ونقلني إلى مقعد خال أمام الطلاب عن يمين المدرس، ÙˆØرمني من متابعة القراءة بإبقاء المسرØية معه، وكان قد هم بقطعها قسمين، ولم يكمل، وألقى القصيدة على الطلاب بيتًا بيتًا وكانت عن الوØدة بين مصر وسوريا التي كانت قد تمت منذ أقل من شهر، ولما Ùرغ سأل: من يستطيع قراءة القصيدة؟ وكانت من Øوالي أربعة وعشرين بيتًا، ومطلعها مازلت أذكره وهو:
سلامٌ شعب سوريّا ومصرا * لقد Øققتَ للتاريخ نصرا ورÙع عدد قليل من الطلاب أيديهم وكنت Ø£Øد الذين رÙعوا أيديهم مستجيبًا لطلب قراءة القصيدة، ÙˆØانت من المدرس التÙاتة إليّ Ùرآني أرÙع يدي، Ùقرَّعني ووبَّخني توبيخًا شديدًا. وقلت له ÙÙŠ أدب شديد: لماذا توبخني؟ Øضرتك طلبت من Ø£Øد الطلاب أن يقرأ القصيدة وأنا واØد من هؤلاء الطلاب. Ùقال لي: أنت لم تكتبها! Ùقلت له: سيادتك طلبت قراءتها وأنا مستعد لذلك. Ùقال مندهشًا: اقرأ. وأسمعته القصيدة كاملة من الذاكرة، وكنت سلّيت Ù†Ùسي بØÙظها منه عند إملائها على الطلاب. وبعد أن Ùرغت من قراءتها، اعتذر لي بشدة عما بدر منه من توبيخي، ÙˆØ§Ù…ØªØ¯Ø Ø°ÙƒØ§Ø¦ÙŠ أمام زملائي، وكان مما قاله لي: “والله يا بني لم أكن أعر٠أنك عبقريâ€ØŒ ÙØ£Øسست أنه ردّ لي اعتباري. وكان الÙضل ÙÙŠ ذلك لقوة الØاÙظة التي مرنت على ØÙظ الشعر، وتمرست به.
ÙÙŠ المرØلة الثانوية عرÙت دار الكتب بÙضل بعض أساتذتي ÙÙŠ المعهد الديني، Ùبدا لي أن الباب الذي ظننته من قبل واسعًا ما هو إلا كوة صغيرة جدًّا على عالم الشعر، ووجدتني أمام تيارات جارÙØ©ØŒ وأرÙ٠عالية تØوي كنوزًا من المعرÙØ© تØتاج إلى أعمار مضاعÙØ© Øتى ينال المرء منها قسطًا Ù…Øدودًا. ولكن الاختيار كان واضØًا لي، إذ توجهت إلى كتب الأدب ÙÙŠ هذا الوقت، وكان هذا الجانب Ù†Ùسه واسعًا جدًّا، Ùكنت أقرأ ما ÙŠØªØ§Ø Ù„ÙŠ منه على غير اختيار. ولم أكت٠ÙÙŠ هذه المرØلة بما يتيØÙ‡ الوقت المØدود من قراءة ÙÙŠ دار الكتب، بل كنت أقتطع مما يعطيني أبي لإقامة الØياة ÙÙŠ القاهرة قروشًا قليلة أشتري بها بعض الكتب المستعملة التي كان باعتها يعرضونها أمام مسجد الجامع الأزهر، Øيث كنا نذهب إليه قبل صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء للمذاكرة ÙÙŠ معظم أيام الأسبوع. وكلما قرأت شيئًا أدركت أن بيني وبين ما أريد من الشعر بونًا بعيدًا تتقطع دونه الأنÙاس.
ÙˆÙÙŠ المرØلة الثانوية تكش٠لي كثير من الأمور. أدركت وزن الشعر دراسة بعد أن عرÙت بعضه اجتهادًا، وبدأت أكتب كلامًا موزونًا مقÙÙ‰ أعرضه Ø£Øيانًا على زملائي ÙيستØسنه بعضهم، ولا يراه بعضهم Øسنًا، وليس بين زملائي وقتها من يقول الشعر أو يهتم به أو ÙŠØاوله. ÙÙŠ هذه المرØلة كانت Ù†Ùسي تتطلع إلى من أجلس إليه يستمع إلى ما أكتب من شعر، ويبدي لي Ùيه رأيًا. ÙˆÙÙŠ شهور الصي٠ÙÙŠ قريتي لم أجد Ø£Øدًا يمكن أن يكون له هذا الاهتمام، ولذلك كنت أسير على قدميَّ مساÙات طويلة لأجلس إلى صديقي عبد الÙØªØ§Ø Ø¹Ù„Ø§Ù… – عليه رØمة الله – الذي كان يسبقني ÙÙŠ الدراسة بسنوات، ويكبرني ÙÙŠ السن بأكثر من سنوات سبقه الدراسي، وكان له اهتمام بالشعر، وكان ÙŠØاول شيئًا منه، ولكن Ù…Øاولاته لم تكن على مستوى Ù…Øاولاتي، ولذلك أعجب بي، وأÙØ³Ø Ù„ÙŠ مجال مصادقته برغم Ùارق السنّ، وكنت أذهب إليه ÙÙŠ قريته المجاورة، وأقضي معه وقتًا طويلا، وأØيانًا أعود إلى قريتي ÙˆØدي ÙÙŠ ظلام الليل الدامس، ÙˆÙÙŠ الطرقات المخوÙØ© المØÙÙˆÙØ© بعدد من المخاطر، وأذكر أنه زادت علاقتي به وثوقًا عندما كتبت إليه مرة قصيدة أهنئه Ùيها بالعيد وأشكو له لواعج الشوق من Øب من Ø£Øبها ÙÙŠ هذه الÙترة، ÙˆÙÙŠ ختام هذه القصيدة أقول:
أشكو إليك وما أخا٠ملامةً * ÙÙ…ÙÙ† اسمها قد رÙÙƒÙّبت أتراØÙŠ
Ùالزاي زادت ÙÙŠ هواي تضرما * والياء قد جلّت عن الإÙصاØ
والنون نلت من الصبابة ما ذوى * بنضارتي ÙَدÙرجت ÙÙŠ الأشباØ
والباء بعد وابتلاء Ø£Øبة * ÙاØÙظه سرًا بين صدرك صاØ
هذي الشكاة زÙرتها ومدامعي * تهمي كصوب الهاتن السØّاØÙ
Ùأجابني العيد السعيد بقوله: * أبدلت منها عابد الÙتاØÙ
ÙامرØÙ’ وغنّ وكن بيوميَ نَاعمًا * واملأ Ùضاء الأÙْق بالتصداØÙ
كان الØب ÙÙŠ هذه المرØلة خيالاً أعيشه ÙˆØدي، لا يدري الطر٠الآخر عنه شيئًا على الإطلاق، وأجد هذا الØب وقودًا يذكى نار الشعر ويلهب أوراها. ÙˆÙÙŠ هذه الÙترة كان هناك شاعر ÙŠØضر كل عام ينشد قصيدة ÙÙŠ ØÙÙ„ بمناسبة المولد النبوي يقيمه أقارب لي، كان اسمه عبد المنعم عبد الله، وهو والد المطرب الذي توÙÙŠ شابًا واسمه عمر ÙتØÙŠØŒ كان هذا الشاعر صديقًا لأØد أقاربي هؤلاء، وكنت Ø£Øسّ أن Ùقرة إلقاء القصيدة ÙÙŠ الØÙÙ„ تخصني ÙˆØدي، ومن المؤس٠أن هذا الشاعر توÙÙŠ شابًّا أيضًا، Ùرأيت أن أخلÙÙ‡ ÙÙŠ Ùقرة الشعر، Ùكنت أستعد للمناسبة بإØدى القصائد التي أسعد بإلقائها ÙÙŠ هذا الØÙÙ„ السنوي، وكنت أغرب ÙÙŠ اختيار الألÙاظ، وكأني منÙلت من العصر الجاهلي، ومثال ذلك ما أقوله ÙÙŠ Ø¥Øدى هذه القصائد عن الهجرة النبوية:
لبستْ قشيب الذكر ذكرى تعبق٠* بشذا البطولة كلّ عام تشرقÙ
ذكرى بصاØبها تهيم تلهّÙا * مضغٌ تلَظَّي ÙÙŠ الضلوع وتØرقÙ
وترنّ إرنان الرَّقÙوب قلوبنا * شوقًا إليها، والكرام٠تشَوَّق
ولكن ملاØظة والدي – رØمه الله – على هذه القصيدة جعلتني ÙÙŠ العام التالي Ø£Ø¬Ù†Ø Ø¥Ù„Ù‰ شيء من السهولة واليسر وأبتعد عن الألÙاظ المقعقعة إذ قال لي: إنك تكتب لنÙسك لأن Ø£Øدًا من الØاضرين لم ÙŠÙهم عنك شيئًا.
Øاولت بالØب أن أليّن لغتي، Ùكتبت لذكاء – وهي الÙتاة التي تزوجتها Ùيما بعد – عددًا من القصائد، وعندما أقول كتبت لها أقصد أنني كتبت عنها؛ لأنها لم تر شيئًا مما كتبته ÙÙŠ هذه المرØلة Øتى الآن، كتبت أهنئها بالنجاØ:
إذا رÙÙ‘ النسيم مع Ø§Ù„ØµØ¨Ø§Ø * وداعب غض أوراق الأقاØÙ
وسال النور من شمس ضØوك * ليوم باسم٠كالØب ضاØÙ
وغردت البلابل Ù„ØÙ† Ùوز * جميل ÙÙŠ الغدوّ ÙˆÙÙŠ الرواØÙ
Ùلا تنسَيْ Ùؤادا ذاب وجدًا * يز٠إليك تهنئة النجاØ
نجاØÙƒ يا ذكاء روى صداه * وأطÙØ£ Ùيه آلام الجراØ
هنيئًا يا ذكاء Ùكل جدّ * Øريّ أن يكلل بالنجاØÙ
وكتبت Ùيها أيضًا :
طلعت ذكاء بØسنها تتألق * وبدتْ Ùخلت Ø°Ùكاء أخرى تشرق
تزجي برقّتها القلوب لساØها * سÙيّان من يهوَى ومن لا يعشق
والشمس إن طلعت ترى عَبّادها * ولّى إليها الوجه Øيث تØلق
طلعت ذكاء Ùهبّ قلبي كي يرى * ذوب الجمال بوجهها يتدÙّق
Ùرأى الضلوع تØول دون مراده * Ùمضى طوال الليل Ùيها يخÙÙ‚
كنت Ø£ØتÙظ بهذا الشعر، وغيره من شعر هذه المرØلة ÙÙŠ أوراقي الخاصة، ولكنه ضاع جميعه مع أوراق أخرى غالية على القلب بعضها يتضمن خطابات والدي وبها شيء من شعره عندما انتقلنا إلى بيتنا الذي نقيم به الآن. ÙˆÙÙŠ المرØلة الثانوية اقتربت من عدد من أساتذتي الذين كانت لهم شهرة ÙÙŠ المجتمع الثقاÙÙŠ والاجتماعي. وأول هؤلاء المØقق العلامة السيد Ø£Øمد صقر، وأØمد الشرباصي، ÙˆÙتØÙŠ عبد المنعم، وعبد الÙØªØ§Ø Ø³Ø§Ù„Ù…ØŒ وعبد المنعم النمر. وكان للسيد صقر أسلوب مختل٠عن زملائه ÙÙŠ التدريس وكان يدرس لنا البلاغة؛ إذ كان يعتمد على إقرائنا نصوصًا من أمهات كتب الأدب ويطلب إلينا أن نبين Ùهمنا الأدبي لها، وكان لا يلتÙت إلى الكتاب المقرر، وإذا التÙت إليه Ùلكي يبين ما به من أخطاء.
وكان مما Ù„Ùت نظر الأستاذ السيد صقر إلىّ أنه طلب مني أن اقرأ أبياتًا ÙÙŠ كتاب ( يتيمة الدهر) للثعالبي، وهي أبيات لسي٠الدولة الØمداني يقول Ùيها:
أقبÙّلÙÙ‡ على جزع٠* كشرب الطائر الÙزعÙ
رأى ماءً Ùأطمعه * وخاÙÙŽ عواقÙب الطمَعÙ
وبعد قراءتها طلب إليّ التعليق عليها، ولم يكد يسمع مني الجملة الأولى التي قلت Ùيها: “هذه أبيات راقصة†Øتى قال: “كÙى، عرÙنا من تكونâ€ØŒ وقربني منه بعد هذه العبارة القصيرة، وقال لي بعد الÙصل: أنت تكتب الشعر؟ Ùقلت له: نعم. كي٠عرÙت؟ قال: التعليق الذي قلته على أبيات سي٠الدولة لا يقوله إلا من ÙŠØب الشعر ويØاول كتابته، وسألني أن أسمعه شيئًا من شعري، Ùأنشدته قصيدة مطلعها:
جاءت إلىّ وكان الشوق Øاديها * والØب أنشودة كانت تغنيها
Ùأخذني معه وجعلني أنشدها للطلاب ÙÙŠ الÙصول الأخرى. رØÙ… الله هذا الأستاذ الشجاع الذي كان يشجع تلاميذه ويأخذ بأيديهم. وكان يطلب إلى بعض الطلاب – وكنت واØدًا ممن طلب إليهم ذلك – أن يذهب إلى قسم المخطوطات بدار الكتب ليØقق Ø¥Øدى القصائد المقررة ويقارن بين الأصل الموجود ÙÙŠ الديوان المخطوط والنص الموجود ÙÙŠ الكتاب، ويكش٠مدى التجاوز والتغيير، ويعرÙنا النتائج التي تترتب على هذا التصØي٠والتØريÙ. وقد Ø£Ùدت من تدريس السيد صقر ما لم Ø£Ùده من الكتاب المقرر الذي كان بعض الطلاب ÙŠØتجون به على السيد صقر ويتنادَوْن من آخر الÙصل: “الكتاب!†Ùيرد عليهم قائلاً: “يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمâ€.
كان أبي معجبًا بأØمد الشرباصي، يتابعه منذ نشأته، وكان يقول لي: إنه كان يقرأ له رسائل ÙÙŠ مجلة (الرسالة) التي كان يرأس تØريرها Ø£Øمد Øسين الزيات وهو بعد طالب ÙÙŠ المرØلة الابتدائية، ولذلك Øين اقتربت منه وقربني إليه وجدت ÙÙŠ ذلك شيئًا ÙŠÙرْضي عني والدي، وأذكر أنني كتبت للشرباصي رسالة طويلة ضمنتها قصيدة ÙÙŠ Ù…Ø¯Ø ØµÙاته، وردّ عليّ برسالة شاكرة مقتضبة يقول Ùيها: “تلميذي النجيب … قرأت رسالتك التي بعثت بها إليّ وقصيدتك التي تÙضلت ÙØييتني بها، وأسأل الله أن يجعلني كما تظن، وآمل أن أراك ÙÙŠ مطلع العام الدراسي وأنت ممتلئ أملاً وثقة†ومهرها بتوقيعه. وعندما أطلعت أبي على هذه الرسالة مباهيًا قال لي: إنه يعلمك كي٠تكون الكتابة! ولكنه لم يستطع أن يخÙÙŠ بعض السرور الذي تسلل إلى أساريره من Ù†Ùسه.
كان السيد صقر جريئًا على النظام السائد ÙÙŠ المعهد الديني كما كان جريئًا على المقرر، Ùكان ÙŠÙدخÙÙ„ معه ÙÙŠ Øصة البلاغة بعض زملائه، Ùمرة يدخل معه Ø£Øمد الشرباصي، ومرة ÙتØÙŠ عبد المنعم، ومرة عبد المنعم النمر، ويدور Øوار يشارك Ùيه الطلاب، ويجني بعضهم من هذا الØوار الØÙŠ Ùائدة كبيرة، وكان السيد صقر يصطØب معه بعض تلاميذه ذوي المواهب من الÙصول الأخرى Ùيلقي على زملائه قصيدة أو يقرأ بØثًا من الأبØاث التي كان يكل٠طلابه بها. وكان قد اصطÙاني أنا ÙˆØامد طاهر لنسخ بعض المخطوطات، وأبلينا ÙÙŠ ذلك بلاء Øسنا، وقد ترددنا كثيرًا على بيته وسهرت معه ليالي ÙÙŠ مكتبه، وكانت أول مرة أرى Ùيها بيتًا غطيت جدرانه من الأرض للسق٠بالكتب، وأنَّى تنقَّل الزائر٠وجد الكتب على هذا النØÙˆ ÙÙŠ كل مكان بالبيت.
عن طريق السيد صقر عرÙت Øامد طاهر وأØمد درويش رÙيقي رØلة الشعر Ùيما بعد. أما Øامد طاهر Ùكان السيد صقر قد دعاه ودعاني معه لتناول الغداء ÙÙŠ Ø£Øد مطاعم الكباب الشهيرة. وقال لنا: ليقدم كل منكم Ù†Ùسه للآخر على الطريقة الشامية. كان Øامد ÙÙŠ Ùصل مختل٠عن Ùصلي وكذلك كان Ø£Øمد لاختلا٠مذاهبنا الÙقهية. وكنت رأيت Øامد من قبل وأنكرت منه أنه لا يلبس الزي الأزهري، وكان Ùتى Ù†Øيلاً أضÙÙ‰ النØول عليه طولا، وكنت أراه مع المترددين على جمعية الشبان المسلمين ÙÙŠ مساء الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وقد غÙر إنكاري عليه عدم ارتداء الزي الأزهري أنْ كنا ليلة Ù†Øضر أمسية شعرية ÙÙŠ جمعية الشبان المسلمين وسمعت زميله المراÙÙ‚ له يقول له: عما قريب نسمعك إن شاء الله وأنت تلقي شعرك ÙÙŠ هذا المكان. إذن هذا الÙتى النØيل الذي لا يرتدي الزي الأزهري شاعر. ووددت لو تعارÙنا؛ ولذلك سررت لدعوة السيد صقر له، وقلت ÙÙŠ Ù†Ùسي جاءت الÙرصة التي كنت أتØينها.
ÙÙŠ هذا اليوم Øدث شيء طري٠شبيه بشيء Øدث من قبل. ÙÙÙŠ طريقنا سيرًا على الأقدام من المعهد الديني إلى العتبة التقينا بشيخ معمم يلبس تØت الزي الأزهري القميص الأÙرنجي والبنطلون، وكانت أزرار كمي القميص من المعدن الأصÙر، ويبدو أنها من الذهب، عرÙت Ùيما بعد أنه الأستاذ Ù…Øمد خليÙØ© الذي صار Ùيما بعد الدكتور Ù…Øمد خليÙØ©. وق٠معه السيد صقر وتكلما بعض الدقائق وأنا ÙˆØامد بجوارهما نسمع ما يقولان ولا نشارك بالطبع Ùيه. وقال Ù…Øمد خليÙØ© للسيد صقر: هل سمعت القصيدة التي قالها Øسن جاد – Ø£Øد شعراء الأزهر المعروÙين – ÙÙŠ هجاء الشيخ عبد الغني عمارة الذي كان قد عين عميدًا لكلية اللغة العربية قبل ذلك بأيام. Ùسأله السيد صقر أن يسمعه إياها، Ùأخرج Ù…Øمد خليÙØ© ورقة قرأ منها القصيدة كان Ùيها من مطلعها:
اعْو٠يا ذئْب٠وانهقي يا Øماره * قد تولّى العمادةَ ابْن٠عمارة
أصبØت دار يعرب غرزة الÙصØÙ‰ وأضØت لأهلها خمارة
لو تراه يدس ÙÙŠ الÙÙ… شيئًا * لا أسميه أو يلÙÙÙ‘ سجارة
إلى أن أنهى القصيدة، ولم تكن طويلة، إذ كانت لا تزيد على خمسة عشر بيتًا، وضØكا معًا طويلاً، ومضى الشيخ Ù…Øمد خليÙØ© متجهًا إلى المعهد، ومضينا متجهين إلى مطعم الكباب ÙÙŠ أول شارع الجيش من العتبة. أكلنا الكباب مع أستاذنا السيد صقر ÙÙŠ مكان Ù…Øترم ولعلها كانت أول مرة، وطلب لنا شيئًا جديدًا علينا يسمى (عيش السرايا). وأثناء أكل الØلو قال السيد صقر: ليتنا كتبنا القصيدة التي ألقاها علينا Ù…Øمد خليÙØ©! Ùقلت له على الÙور: لا بأس، يمكن أن نكتبها الآن. ÙدÙÙ‡ÙØ´ الرجل، وأخرجت ورقة وقلمًا وكتبت له القصيدة كما ألقاها الشيخ Ù…Øمد خليÙØ© لم أخرم منها بيتًا. ÙسÙرَّ السيد صقر بكتابة القصيدة، وبØÙظي لها من سماعها أول مرة، وكان بعد ذلك يسميني ذا الذاكرة الذهبية.
مشينا معَ السيد صقر Øتى أوصلناه إلى بيته، وشكرناه، ومضينا معًا Øامد وأنا، وقد تعلقت به تعلقًا شديدًا، وظللنا معًا نمشي ÙÙŠ شوارع القاهرة ونتكلم ÙÙŠ أمور الشعر وأسمع منه شعره، وأÙسمعه، ولÙت نظري أن شعره مختلÙØŒ Ùعلى Øين كنت Ø£Ø¬Ù†Ø Ø¥Ù„Ù‰ الألÙاظ المعجمية الجزلة، كان Ù„Ùظه سهلاً عذبًا لطيÙًا مأنوسًا، وعلى Øين كنت أكتب عن هجرة ÙˆÙ…Ø¯Ø Ø§Ù„Ø±Ø³ÙˆÙ„ صلى الله عليه وسلم، كان يسمعني شعرًا عن ثورة يوليو وأم كلثوم وبعض المشاعر عن الأعمى والخادم، وهجاء بعض المشايخ ÙˆÙ…Ø¯Ø Ø¨Ø¹Ø¶Ù‡Ù…. وقد أثنى يومها على قصيدة لي كنت قد كتبتها بعنوان (الØب الدÙين). قلت لنÙسي: صار لي صديق شاعر Ùعضضت على صداقته بالنواجذ. وسرعان ما انضم إلينا Ø£Øمد درويش وكان قد أعجبني منه من قبل أنه كان يلقي ÙÙŠ Ùصلنا بØثًا عن ابن الرومي، وأثناء قراءته للبØØ« انتزع منه الأوراق وطلب إليه أن يستمر، Ùلم يتلعثم Ø£Øمد واستمر ÙÙŠ الكلام كأنه يقرأ من كتاب Ù…ÙتوØ. ولكن بعد ذلك بأيام أعلن السيد صقر أن إدارة المعهد واÙقته على عمل مجلة طلابية تنشر Ùيها بØوث الطلاب – وكنت بتوجيه منه أعددت بØثًا عن البØتري وأعد Øامد بØثًا عن المتنبي وأعد Ø£Øمد بØثًا عن ابن الرومي – والت٠الطلاب يسألون الأستاذ عن كيÙية النشر وشروطه، ووقÙت Ø£Ùكر ÙÙŠ سؤاله عن الشعر، وبينما كنت أدير السؤال ÙÙŠ Ù†Ùسي وأØاول اختيار العبارة التي أصوغه بها Ù‚Ùز Ø£Øمد درويش وكان صغير الØجم ولا يرتدي أيضًا الزي الأزهري وقال للأستاذ السيد صقر: هل سيكون للشعر نصيب ÙÙŠ هذه المجلة؟ وأعجبني سؤاله عن الشعر واقتØامه، Ùأمسكت بيده وأخذته بعيدًا عن التØلق Øول الأستاذ وسألته: لماذا تسأل عن الشعر؟ Ùأجابني باعتداد كبير إنه شاعر قد اختطّ لنÙسه الدÙاع عن القضايا الإسلامية. ومرة أخرى أعجبني منه أنه يتكلم بثقة عن طريق واضØØŒ وخط مرسوم.
التقينا إذن ÙÙŠ Øمى أستاذنا السيد صقر ÙˆÙرØنا بهذه العلاقة ÙرØًا شديدًا، أو على الأقل ÙرØت أنا بهذه العلاقة ÙرØًا شديدًا، وقد تعلمت Ùيما بعد أنه ÙÙŠ مجال العاطÙØ© لا أتكلم إلا عن Ù†Ùسي.
بدأت علاقة هذا الثلاثي ÙÙŠ أوائل السنة الثالثة الثانوية، وكان أمامنا للØصول على الثانوية الأزهرية سنتان بعد الثالثة، وكنا إذا ذهبنا إلى قرانا ÙÙŠ الصي٠بقى Øامد ÙÙŠ القاهرة Øيث يقيم أهله، ويتردد على دار الكتب، ويقيم علاقات متنوعة، وكنا نتراسل أسبوعيًا Ùيكتب لي Øامد عما يقرأ ÙÙŠ دار الكتب وغيرها، ويكتب لي آخر ما كتب من الشعر، ÙˆÙÙŠ بعض الأØيان يكتب شيئًا من الشعر يخصني، ولا أنسى قصيدة كتبها لي يهنئني Ùيها بالعيد يقول Ùيها:
إليك أسوق تØناني * ومنك أصوغ ألØاني
وقد يتجرأ الإنسان * لكن أنت إنساني
عرÙتك Ùاهتدى قلقي * ورقّ لديك وجداني
وعبّ النورَ من إخلاصك الÙطريÙÙ‘ Øرماني
Ùياكم عشت ÙÙŠ الدنيا * غريبًا بين خلاني
ألاقي ما يلاقي الطير٠خل٠عَتÙيّ قضبانÙ
وأرد عليه بقصيدة مماثلة أبادله Ùيها المودة بمثلها، وأهنئه أيضًا بالعيد، آخرها:
Ùعيدي ليس عيد الناس لكنْ يوم تلقاني
ويكتب إليّ مرة بعد أداء الامتØان ÙÙŠ السنة التي رَدّت Ùيها السعودية كسوة الكعبة المشرÙØ©ØŒ وأمر جمال عبد الناصر أن تعلق كسوة الكعبة ÙÙŠ مسجد الجامع الأزهر ÙØ£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø£Ø²Ù‡Ø± مزارًا Ù„Ùئات مختلÙØ© من الرجال والنساء والشباب والصبيان والÙتيات، واختلط الØابل بالنابل ÙÙŠ الأزهر الشريÙØŒ واشتد الزØام، وضاعت Øرمة المسجد، كتب Øامد لي يقول:
أتذكر يا Ù…Øمد يوم كنا * نؤل٠من صÙاء الØب Ù„ÙŽØْنا
غداة نعيش ÙÙŠ بؤس امتØان٠* ولكن السعادة ÙÙŠ يدينا
وأرد عليه قائلاً:
أجلْ ذكراك لا تÙنْسى * Ùلن أنساك لن أنسى
أأنسى Øلو أيام * همسن بعمرنا همسَا
وطاÙتْ بي صباباتٌ * عÙذابٌ ÙƒÙنّ لي أنسا
وطÙْتَ بها لتسقيني * وتملأ بالرضا النÙسا
إلى أن أنهيها قائلاً:
Ùليت الإمتØان بَقÙÙŠ * وليت البيتَ لا ÙŠÙكسى
ÙÙŠ الشهور الأولى من السنة الرابعة الثانوية دعانا السيد Ø£Øمد صقر Ù†ØÙ† الثلاثة، وطلب إلينا أن يعد كل واØد منا قصيدة ÙÙŠ Ù…Ø¯Ø Ø§Ù„Ø£Ø³ØªØ§Ø° العقاد لكي نزوره ونلقي عليه شعرنا ÙÙŠ مدØÙ‡ والثناء عليه، ولم نعر٠الغرض من هذه الزيارة إلا أننا سعدنا بالÙكرة، ونهضنا للمهمة التي كلÙنا بها، واتÙقنا Ùيما بيننا أن تكون قصائدنا من بØر واØد هو الكامل، وأن يكون الروي واØدًا هو الدال المكسور المردÙØ© بالأل٠– وهذا بالطبع Øتى ØªØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ÙƒÙ„Ù…Ø© (العقاد) – وألاّ ÙŠÙطلÙع Ø£ØدÙنا الآخرَ على القصيدة إلا يوم إلقائها أمام العقاد Ù†Ùسه.
وبعد أن انتهينا من قصائدنا أبلغنا أستاذنا السيد Ø£Øمد صقر، ÙØدد لنا يوم الجمعة إذ كانت ندوة العقاد تبدأ ÙÙŠ الØادية عشرة من ØµØ¨Ø§Ø ÙŠÙˆÙ… الجمعة كل أسبوع، ÙˆØدد لنا المكان الذي ننتظره Ùيه ÙÙŠ ميدان روكسي بمصر الجديدة، وذهبنا إلى المكان المØدد، وانتظرْنا أستاذنا وقتًا طويلاً، Ùقررنا الذهاب إلى بيت العقاد بدونه، وذهبنا، وكانت القاعة غاصة بكثير من زملائنا الذين تسرب إليهم خبر هذه الزيارة، وهناك وجوه طبعًا لمشاهير من رجال الثقاÙØ© والأدب والÙن، وكان العقاد Øين دخلنا هائجًا غاضبًا، يتكلم بكلام ثائر، وعرÙنا من خلال Øديثه الغاضب أن بعض الØاضرين أثاره بسؤال عن الشعر الØرّ، Ùكان مما يقول إن القاÙية ضرورية للشعر، لأن الشعر ÙÙ† له قيوده، وكل ÙÙ† له قيوده، ولا يكون الÙÙ† Ùنًّا إلا إذا Øقق هذه القيود، وإليك ديوانًا من دواوين الشعر الصيني، انظر ÙÙŠ آخر الأسطر وأنت لا تعر٠الصينية، Ùسو٠تجد أن الØر٠الأخير من كل بيت – وهو Øر٠الْقاÙية – يتكرر ÙÙŠ كل بيت، أي إن الشعر الصيني يلتزم بقاعدة الشعر والقاÙية Ùيه استجابة لهذا الالتزام. وكان هذا الكلام جديدًا عليّ تمامًا، ولما سكت عن العقاد الغضب عم القاعة سكون شامل مهيب، وكان هناك شاب يتØرك بين الجالسين ويشير Ù„Øامل العصير أن يوزع عليهم، وعرÙت بعد هذا أنه عامر العقاد ابن أخي الأستاذ العقاد، Ùانتهزت Ùرصة مروره بجانبي، وقلت له إنّ معي قصيدة ÙÙŠ Ù…Ø¯Ø Ø§Ù„Ø¹Ù‚Ø§Ø¯ وأريد أن ألقيها عليه، Ùقال لي مرØبًا: إن الأستاذ لا يهدأ إلا بالشعر، وقَدَّمني لجمهور الØاضرين، ووقÙت متشجعًا بما قدمني به، وبدأت أنشده قصيدتي، وكانت هناك مقدمة، بعدها أقول:
يا سيدي هذي تØية مبتد٠* متعثÙّر ÙÙŠ ساØØ© الإنشاد
Øار اليراع براØÙ‡ متهيبا * وتعللت Ø´Ùتاه: ج٠مدادي
Ùهناك قال القلب خذني ريشة * واكتب بها من لوعة الأكباد
Ø³Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ù„Ø§Ù… بما سأملي ضيّقٌ * لا سيما ÙÙŠ ساØØ© العقاد
وعندما ألقيت البيت الأخير رجّ تصÙيق الØاضرين – وأغلبهم كما قلت من زملائنا بالمعهد – أرجاء القاعة، Ùازداد تماسكي وقويت شجاعتي ومضيت:
لكن ترى ماذا أقول ومدØÙ‡ * شدو Ø§Ù„ØµÙˆØ§Ø¯Ø ÙˆØ§Ø³ØªÙ…Ø§Ø± النادي؟
أأقول نبع ترتوي ÙÙŠ غبطة * منه العقول كنهر نيل الوادي
أأقول شمس للمعار٠أشرقت * أأقولها والشمس دون مرادÙÙŠ
Ùالشمس تشرق ثم تغرب وهو من * إشراقه أبدًا سنًا متهادÙ
وقد قوطعت بالتصÙيق أكثر من مرة، ولما أنهيت إلقائي هبّ العقاد واقÙًا Ùرأيته عملاقًا شامخًا، ومدّ يده إلى مصاÙØًا وقال لي: هات القصيدة، Ùأعطيته إياها، ولم يكن عندي نسخة أخرى منها، وما بقي منها بقى ÙÙŠ ذاكرتي. بعد هذا قدم Ø£Øمد درويش Ù†Ùسه قائلاً: وهذا مبتدئ آخر، وألقى قصيدته، وقام Øامد Ùألقى قصيدته. ÙˆØضر أستاذنا بعد أن Ùرغنا من إلقاء قصائدنا، وعرÙنا بعد أنه تأخر لصلاة الجمعة، وبعد أن انتهت الندوة استبقانا الأستاذ العقاد مع السيد صقر، وسألنا: هل أنتم طلاب ÙÙŠ دار العلوم؟ Ùقلنا له: إننا مازلنا ÙÙŠ الرابعة الثانوية بالمعهد الديني، ÙنصØنا بدخول دار العلوم وظل يتكلم عن دار العلوم ودورها ÙÙŠ الØياة الثقاÙية وأن الØركة إليها ذهابًا وجيئة أشبه بخط النمل، مما جعلنا نعقد العزم على الالتØاق بدار العلوم. وقال لنا عن السيد صقر: إن أستاذكم هذا رجل مجهول القدر ÙÙŠ هذا البلد!
خرجنا من بيت العقاد قرب العصر ونØÙ† نكاد نطير من النشوة والسرور، Ùقال أستاذنا: سنذهب الآن لزيارة شخصية أخرى مهمة لا تقل عن العقاد أهمية، وسألنا: من؟ Ùقال: الأستاذ Ù…Øمود شاكر. ولم نكن نعر٠عنه Øتى ذلك اليوم شيئًا، وذهبنا معه طائعين. ÙˆÙÙŠ بيت الأستاذ شاكر وجدنا جمعًا أقل عددًا ولكنهم – Ùيما بدا من سمتهم – من الصÙوة، ومن أسمائهم عرÙنا أن بعضهم من البلاد العربية Ùكان من سوريا راتب النÙاخ، وإØسان النص، ومن الأردن ناصر الدين الأسد، ومن السودان عبد الله الطيب، ومن مصر عدد أولهم الشاعر Ù…Øمود Øسن إسماعيل. والمضØÙƒ ÙÙŠ هذا اليوم أن أستاذنا السيد صقر طلب منا بعد أن ذهبنا إلى بيت الأستاذ شاكر أن نخلو إلى أنÙسنا ÙÙŠ “الÙرندة†ونكتب تØية بالشعر للأستاذ Ù…Øمود شاكر. واستجبنا ÙˆØاولنا، وكتب كل منا أبياتًا ÙÙŠ غاية الغثاثة والرداءة. وكان هذا Øدثًا ظللنا نضØÙƒ له ونخجل منه زمنًا طويلاً. عندما أذن لصلاة المغرب هبّ جميع الØاضرين للصلاة، وأمَّهم صاØب البيت الأستاذ Ù…Øمود شاكر وبعد الصلاة استنشده الØاضرون قصيدته الÙريدة (القوس العذراء) وبدأ ÙÙŠ الإنشاد، وتلبسه Ø±ÙˆØ Ù…Ø®ØªÙ„Ù Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ الإنشاد، وبعد قليل ÙÙƒ رباط عنقه، واستمر ÙÙŠ الإنشاد وبدأ يتصبب عرقًا مع أن الوقت كان شتاء وبعد أن انتهى من إنشاده قال: (إن الشعر العربي ينبغي ألا ينشد إلاّ ÙÙŠ زي عربي، لأن هذا الزي لا يناسبه).
عندما استمع إلينا أستاذنا ÙتØÙŠ عبد المنعم قال: لابد أن نعقد لكم ندوة بالمعهد لكي يسمعكم زملاؤكم، وطلب من شيخ المعهد أن يواÙÙ‚ على عقد هذه الندوة وواÙÙ‚ شيخ المعهد على أن تكون يوم الخميس بعد انتهاء اليوم الدراسي. وتØدد اليوم، وأعلن عنه، وعن القاعة التي ستكون Ùيها الندوة، ولما جاء الوقت المØدد لم يكن ÙÙŠ القاعة معنا Ù†ØÙ† الثلاثة سوى ÙتØÙŠ عبد المنعم. وانتظرنا بعض الوقت ولم ÙŠØضر Ø£Øد، ولست أنسى Øزن ÙتØÙŠ عبد المنعم يومها وأسÙÙ‡ الشديد من أجل ما آلت إليه أمور الطلاب وأمور إدارة المعهد التي تعسÙت ÙÙŠ تØديد هذا الموعد، مع أننا كنا نضØÙƒ ساخرين.
اكتشÙنا أنه لم يكن بالمعهد غيرنا يكتب الشعر عندما دعا شيخ المعهد – وكان اسمه الشيخ Ù…Øمد سباق – كل من يكتب الشعر من الطلاب للالتقاء به ÙÙŠ مكتبه ÙÙŠ موعد Øدده لذلك. ÙÙŠ الموعد المضروب لم نجد Ø£Øدًا سوانا Ù†ØÙ† الثلاثة ÙÙŠ مكتب شيخ المعهد، وألقى إلينا بالمهمة المطلوبة وهي أن يكتب كل منا قصيدة عن (الميثاق) الذي أصدره المؤتمر الوطني ÙÙŠ عهد جمال عبد الناصر، وسو٠يقام اØتÙال كبير بهذه المناسبة ويوزع Ùيه أيضًا جوائز المتÙوقين دراسيًا – وكنت منهم طوال سنى الدراسية بالمعهد – وسو٠نختار قصيدة واØدة Ùقط للإلقاء ÙÙŠ هذا الØÙÙ„ØŒ عندما خرجنا من مكتب شيخ المعهد بادرنا Ø£Øمد بأن عنده قصيدة جاهزة ÙÙŠ الميثاق – وكان عضوًا بالمؤتمر الوطني – وقال Øامد: إنه ليس لديه الرغبة ÙÙŠ المشاركة ÙÙŠ هذا الØÙÙ„. وليلة الØÙÙ„ سألني زملائي الذين كنت أسكن معهم عن قصيدتي التي سأقدمها لشيخ المعهد غدًا، Ùقلت لهم إن هناك قصيدة واØدة هي التي ستلقى، وأنا لم أكتب شيئًا Øتى الآن ÙاستØثوني على الكتابة، وقالوا: إن شيخ المعهد سو٠يدعكم جميعًا تنشدون قصائدكم إذا قدمتموها له. Ùأخذت – وكان ذلك ÙÙŠ التاسعة مساء – ÙÙŠ كتابة قصيدة أذكر منها ÙÙŠ المطلع :
من ÙˆØÙŠ عبد الناصر العملاق * صيغت إليك مبادئ الميثاق
ÙˆØÙŠÙŒ تنزَّل كي يشيد دعامة * للمجد، والتاريخ، والأخلاق
وأنهيتها ببيتين Ø£Øيي Ùيهما شيخ المعهد قائلاً:
وإليك يا شيخي الكريم تØية * Ùلكم نرى من عطÙكم ونلاقي
ولقد سبقت إلى المØامد كلها * Øتى دعيت Ù…Øمد بن سباق
ÙˆÙÙŠ Ø§Ù„ØµØ¨Ø§Ø Ø£Ø¹Ø·ÙŠØª القصيدة لشيخ المعهد، وقبل بدء الØÙÙ„ بدقائق وجدت شيخ المعهد بنÙسه ينادي على من اسمه Ù…Øمد Øماسة Ùدخلت مكتبه وكان Øوله مجموعة من المشايخ، Ùقال لي: إن قصيدتك هي التي اختيرت وسو٠تلقيها ÙÙŠ الØÙÙ„ بشرط واØد هو ألا تلقي البيتين الأخيرين منها، Ùقال Ø£Øد الØاضرين وهو الشيخ عبد الوهاب Ùايد – وكان معروÙًا بمعارضته لكثير مما ÙÙŠ النظام الأزهري – يا مولانا، وهل اختيرت هذه القصيدة للإلقاء إلا من أجل البيتين الأخيرين؟ وأعجبت بجرأة الرجل وصراØته. ÙˆÙÙŠ هذا اليوم تكشÙت لي أمور كان مغطَّى على بصري Ùيها لم يزدها توالي الأيام إلا تأكيدًا. ÙÙŠ صبيØØ© اليوم التالي أدار الدكتور عبد الÙØªØ§Ø Ø³Ø§Ù„Ù… – وهو أستاذنا ÙÙŠ التÙسير – الØصة على قصيدتي، وكانت أول مرة أسمع Ùيها نقدًا على عمل لي، وكان لطيÙًا متسامØًا، يقيم نقده على المعطيات اللغوية، وقد وق٠طويلاً أمام (Ùلكم نرى من عطÙكم ونلاقي)ØŒ وكان يضØÙƒ كثيرًا وهو يتهمني بالمكر ÙÙŠ ØØ°Ù Ù…Ùعول الÙعل (نلاقي) ويقول: Øددت ما ÙŠÙرى وهو العط٠، ÙˆØØ°Ùت ما “نلاقيâ€ØŒ إن الÙعل “نلاقي†لا يستعمل إلا Ùيما يدل على معاناة ومشقة، Ùلعل التقدير (ونلاقي صنو٠العنت) أو (أنواع الهوان) ويغرق ÙÙŠ الضØÙƒ أكثر، وهو يقول : أية Ù…Øامد سبق إليها شيخ المعهد، لقد أغرتك مادة (الØمد) ومادة (السبق) Ùجعلت منه سبَّاقا إلى المØامد كلها، إنه سباق لغوي، ÙˆØمد لغوي، وهو كذب، ولكن أعذب الشعر أكذبه. ويسترسل ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ù…Ø¹Ø§Ù† لم تخطر لي على بال بطبيعة الØال، ولكن كان لكثير مما قال أثر كبير ÙÙŠ Ù†Ùسي المتطلعة، وكان ما قاله Ø£Øسن ما Øظيت به ÙÙŠ معهد القاهرة الديني الذي ظÙرت Ùيه بصØبة رÙيقي درب الشعر Øامد طاهر وأØمد درويش، وكانت مناقشتنا المستمرة Ø¥Øدى وسائلنا ÙÙŠ تطوير أدائنا الشعري.
التØÙ‚ ثلاثتنا بكلية دار العلوم التي كانت أملا يراودنا ÙˆØلما يداعب أخيلتنا لما نسمعه من نشاطها الدائب ÙˆØركتها المستمرة ÙÙŠ الشعر ونقده، والتي أوصانا بها الأستاذ العقاد ونصØنا بالالتØاق بها، وكان ذلك على غير رغبة والدي الذي نذرني للأزهر، وكان يريدني أن أتخرج Ùيه، واتهمني بأني التØقت بها من أجل وجود الاختلاط Ùيها، وبعد لأي ما قبل وجودي بها. وقضينا أيامنا الأولى بها ÙÙŠ تعرÙها واختبار ما Ùيها، وبعد مرØلة لم تطل من الاضطراب والقلق تكيÙنا مع الوضع الجديد، والنظام الجديد، ÙŠØدونا الأمل، ويدÙعنا التطلع أننا سو٠نشق الصÙÙˆÙ Ùيها إلى المقدمة بما نملك من موهبة وبما يملأ قلوبنا من الشعر، ولكنه الأمل المشوب بالرهبة من الأسماء الكبيرة التي كنا نتسامع بها ÙÙŠ الشعر والنقد، وبعد التغلب على الإØساس الطارئ بالشعور بالغربة لأننا ÙÙŠ أرض غير الأرض التي ألÙناها تسع سنوات كاملة من سني التعلم شجعنا زملاؤنا الأكبر سنا الذين كانوا أزهريين مثلنا، وكانوا زملاء لأخي Øامد الأكبر سنا وهو Ø£Øمد طاهر، وكان مجرد كلام واØد منهم لنا كلاما عابرا يثبت القلب والأقدام ÙÙŠ هذه الأرض الجديدة.
بعد شهر تقريبا من بدء الدراسة رأينا إعلانا على السبورة ÙÙŠ Ùناء الكلية – المبني القديم بالطبع نضر الله أيامه بكل خير – يدعو الطلاب الذين يكتبون الشعر للقاء مع مقرر جماعة الشعر، وكان علي البطل – رØمه الله – وهو طالب وقتها ÙÙŠ الÙرقة الثالثة. والتقينا ووجدت عددا كبيرا من الطلاب يملأون مدرج (Ø£)ØŒ يا لله ! كل هؤلاء يقولون الشعر؟ أين معهد القاهرة من هذا الثراء الخصيب ÙÙŠ المواهب؟ ÙˆØ´Ø±Ø Ù„Ù†Ø§ مقرر جماعة الشعر النظام المعمول به، وعرÙنا أن هناك لقاء أسبوعيا ÙÙŠ يوم الخميس، يختار Ùيه عدد من القصائد يلقيها أصØابها ويعلق عليها Ø£Øد الأساتذة ومنهم المعيدون. وقدمت قصيدة جديدة كتبتها أيامها من ÙˆØÙŠ ما شاهدته من بعض زميلاتي ÙÙŠ الكلية أقول Ùيها:
لا تقيمي على الجمال ستارا * من مساØيق تصرخ استهتارا
وثقي بالذي برته يد الله Ùقد أبدعت لنا الأزهارا
أنت يا أخت٠درّةٌ والدراري * غاص من أجلها الأنام البØارا
وقدم Ø£Øمد درويش قصيدة طويلة – وهي القصيدة التي أسمعنيها أول ما عرÙته – ولم يقدمنا مقرر الجماعة ÙÙŠ لقاء الخميس الأول، وعندما ذهبت أسأله قال لي: إن قصيدتك مقبولة لأن (عايدة) أعجبت بها (عايدة زميلته التي تزوجها Ùيما بعد)ØŒ Ùسألته عن قصيدة Ø£Øمد ألم تعجب بها عايدة Ùنظر إلىَّ شزرًا قائلاً: إنها ليست قصيدة، Ùقلت: إنها أكثر من ستين بيتا، Ùقال قولة لم أنسها قط: (Ù†ØÙ† لا نقيس الشعر بالشبر).
كان المعلق على قصائد الندوة هذه المرة هو الدكتور عبد الله درويش – رØمه الله – وقال عن قصيدتي كلاما مال Ùيه إلى التشجيع لا المؤاخذة مما أغراني بتقديم قصيدة أخرى كانت من بØر الخÙي٠وكنت سعيدا بها لأنها أول مرة أكتب Ùيها من هذا البØر الذي يعز على الشادين، وكانت بعنوان (Øطم العود) أقول Ùيها:
Øطم العود يا صديقي Ùإني * Ùوق صخر الأسى تØطم عودي
بعثر اللØÙ† يا رÙيقي Ùإني * غير مصغ لضاØÙƒ التغريد
ما مراØÙŠ وبهجتي ومزاØÙŠ * وصداØÙŠ ÙˆÙرØتي ونشيدي
ÙÙŠ Øياة تعكّر الصÙÙˆ قسرًا * وبكأس انتشاءة المرء تودي
بينما المرء ÙÙŠ ربيع شباب * باسم الثغر للغد المنشود
يتثني بعوده الغض مزهوًّا بثوب الشباب كالعنقود
كالربيع الضØوك تهتز Ùيه * خطرات الصبا Ø¨ØµØ¨Ø Ø¬Ø¯ÙŠØ¯Ù
إذ يسوق الردى إليه سهامًا * ثم يودى بغصنه الأملودÙ
كان الذي يعلق هذه المرة هو Ù…Øمد ÙØªÙˆØ Ø£Øمد، وكان معيدا لامعا واثقا بنÙسه، وكان شاعرًا من شعراء الكلية المعدودين، وكنا نعجب بشعرة ونرى Ùيه نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة الØديثة، وقد هاجم ÙÙŠ هذه الندوة قصيدتي هجومًا قاسيا، ورمى شاعرها بالÙشل، ÙˆØ±Ø§Ø ÙŠØ¹Ø¯Ø¯ الأسباب التي ساعدت الشاعر على هذا الÙشل، وكلما قال شيئًا تضاءلت ÙÙŠ مقعدي ووددت لو اختÙيت من هذا المكان، وأذكر أنني خرجت بعدها Ùلم أذهب إلى البيت، وظللت هائما على وجهي ÙÙŠ طرقات القاهرة، لا أدري بالوقت ولا أشعر بالمكان، وكان عقلي يعيد النظر ÙÙŠ أمر الشعر كله، كنت أقول لنÙسي: هذا الشعر الذي كنت تعتز به وتØبه، وتشعر به بالتميز على زملائك وأندادك الذين لا يقولون الشعر هو اليوم سبب لشعورك الأليم بالخزي والهوان، وقرت Ù†Ùسي يومها على هجر الشعر وتركه، Ùقد كنت أعدّه سببا لظهوري بين زملائي وتÙوقي عليهم، الآن هو سبب لشعوري بالتضاؤل بينهم. ومضيت بعد أن انتهيت إلى هذا القرار لبيتي وارتاØت Ù†Ùسي لما قررت وكنت أرى وقتها أنصا٠الشعراء ÙÙŠ الكلية لا ÙŠØققون راØØ© بالتÙوق ولا راØØ© باليأس، واليأس Ø¥Øدى الراØتين، وقلت: لنÙسي إما أن Ø£Øقق بالشعر مكانة عليا وإما أن أصمت، Ùليس كل المتÙوقين شعراء ولتكن الدراسة مجالا للتÙوق. وظل Øديث النÙس هذا يلازمني Øتى كان الأسبوع التالي، وقد دعانا زميل من أريتريا اسمه عبد القادر – وكنا نسميه عبد القادر الأريتري – إلى ناد٠خاص بالجالية الأريترية، وذهبنا Ù†ØÙ† الثلاثة Øامد وأØمد وأنا، ولم يكن هناك شعراء مدعوون لهذه الأمسية سوانا، وكان الذي يعلق على الندوة هو Ù…Øمد ÙØªÙˆØ Ø£ÙŠØ¶Ù‹Ø§ØŒ وقدمت قصيدة ÙÙŠ هذه الليلة بعنوان (البغيّ) وكانت صياغتها مختلÙØ© عما ألÙته من قبل، وعندما وجدت أن المعلق هو Ù…Øمد ÙØªÙˆØ ÙˆØ·Ù†Øª النÙس لتلقى مزيد من الاتهام بالÙشل، ولكن Ù…Øمد ÙØªÙˆØ ÙÙŠ هذه الليلة أهمل الإشارة إلى قصيدتي تمامًا سلبا وإيجابًا، وأسمع كلاًّ من Ø£Øمد ÙˆØامد عن قصيدتهما ما أسمعنيه عن قصيدتي ÙÙŠ ندوة دار العلوم وكان لاذعًا قاسيا، أو بدا لنا الأمر كذلك. والØÙ‚ أن بعض كلامه كان مبادئ نقدية عرÙنا بعد قليل أنها مستقاة من Ù…Øمد غنيمي هلال ÙÙŠ كتابه مدخل إلى النقد الأدبي الØديث الذي كان يدرسه لنا ÙÙŠ هذا العام، وغير عنوانه ÙÙŠ هذا العام Ù†Ùسه إلى (النقد الأدبي الØديث). وقد خرجنا Ù†ØÙ† الثلاثة هذه الليلة نمشي ÙÙŠ شوارع القاهرة ونضØÙƒ مما Øدث، ويبدو أن تساندنا معا، لم يصبنا بما أصبت به ÙÙŠ الأسبوع السابق. وكان Øامد أكثرنا ثباتا وثقة Ùقال: إن ÙØªÙˆØ ÙŠØ¹Ù„Ù… مقدار موهبتنا لأنه شاعر قبل أن يكون ناقدًا، وهو يخشى من وجود قوة شعرية ÙÙŠ مثل قوتنا ÙÙŠ الكلية، Ùقد تنال هذه القوة الجديدة من مكانته المستقرة، ولذلك يريد أن يخيÙنا ويÙزعنا، ومن ثم ينبغي ألا Ù†Øقق له ما يريد ولكن الأمر لم يكن على ما صوّر Øامد، وإن كان موقÙÙ‡ أعاد إلينا الثبات. كان ÙØªÙˆØ Ø£Øمد يمارس أدواته النقدية التي تعلمها، وكان يقسو من أجل الرغبة ÙÙŠ دÙعنا إلى تطوير أدواتنا الشعرية وتصØÙŠØ Ù…Ùهومنا عن الشعر، وسرعان ما ضمنا إليه ÙˆØ³Ù…Ø Ù„Ù†Ø§ بالجلوس معه وزيارته ÙÙŠ بيته ولكننا ظللنا ننطوي على شيء من الرهبة له والخو٠منه. الآن بعد مرور أربعين سنة عندما أتذكر معه هذه المواق٠يضØÙƒ ضØكة Ùيها شيء من الزهو، وشيء من الأسى أَنْ لم ÙŠÙÙْهم موقÙÙ‡ ØÙ‚ الÙهم.
ÙÙŠ السنة الأولى بدار العلوم Øدث موقÙان آخران لهما بالشعر صلة، أمّا أولهما Ùقد أعلنت إدارة رعاية الشباب للذين يكتبون الشعر أن يتقدموا بقصائدهم لاختيار من يشاركون منهم ÙÙŠ أسبوع شباب الجامعات، ÙˆØدد موضوع القصيدة أن يكون قوميا، وتقدمت بقصيدة زاعقة مطلعها:
ق٠يازمان من السنا المتهادي * Øيّ انطلاق الÙجر ÙÙŠ بغداد
Ù‚Ù Øيّ Ùيها ثورة عربية * Ù…Øقت ظلام الظلم والإÙساد
واختير ÙÙŠ هذا العام سعد Ù…ØµÙ„ÙˆØ ÙˆØامد طاهر، كانت قصيدة سعد جميلة بعنوان (الصÙصاÙØ©) مطلعها:
Øنّ من رقة وأنّ صبابهْ * وأذاب العذاب Ùيّ شبابهْ
وكانت قصيدة Øامد رباعية رائعة بعنوان (الراعي) ومطلعها:
من ربوة خضراء نائمة بأØضان الجبلْ
ساق النسيم الصبّ أغنية كرنّات القÙبَلْ
إلى هنا والأمر مألو٠ليس Ùيه شيء غير عادي، Ùقد سعدت Ù„Øامد كما لو كانت قصيدتي هي التي اختيرت، وكنا وقتها Ù†Øسب أنÙسنا Ù†Ùسا واØدة إذا Øقق Ø£Øدنا شيئا ÙØ±Ø Ù„Ù‡ الآخران، وإن كنت طويت النÙس على أن Ø£Øسّن وأجوّد ÙÙŠ شعري لقابل. وقد ألغي أسبوع شباب الجامعات بعد هذا العام. غير المألو٠دعوة الدكتور عبد الØكيم بلبع – عليه رØمة الله – لي عن طريق رعاية الشباب، وكانت أول مرة ألتقي به، وكنت أضرب أخماسا ÙÙŠ أسداس، وطار من قلبي طائر الأمن، Ùلما التقيت به Øياني بابتسامته البشوش ووجهه الطلق وكلماته المشجعة، وناداني باسمي كأنه يعرÙني من زمن بعيد، وقال لي: أرجو ألا تكون غاضبا لعدم اختيار قصيدتك، قصيدتك جيدة، وكان عدم اختيارها عن غير قصد، وطيب خاطري بكلام جميل، وكان هذا اللقاء وهذا الكلام الجميل عندي أجمل مما لو اختيرت قصيدتي. وكان كلامه معي درسًا لي لم أنسه قط كلما تعرضت بعد ذلك لموق٠الØكم. ولم ينزع Ù…Øبته من قلبي شيء Øتى ÙˆÙاته ÙÙŠ سنة 1977Ù… رØمه الله.
وأما الموق٠الآخر Ùقد علق إعلان ÙÙŠ الكلية أنها ستقيم ØÙÙ„ تأبين ÙÙŠ ذكرى الأربعين للأستاذ العقاد الذي توÙÙŠ يوم 12/3/1964ØŒ وسو٠يلقي Ùيه الأستاذ عمر الدسوقي بØثا عنه، وسيكون هناك مجال لإلقاء قصيدة ÙÙŠ رثائه، وعلى الراغبين ÙÙŠ المشاركة أن يقدموا قصائدهم للأستاذ ÙØªÙˆØ Ø£Øمد، وتقدمت ضمن من تقدموا، ولم يتقدم Øامد مع أنه كتب قصيدة ÙÙŠ رثاء العقاد، وكان رأيه أن التقديم ÙÙŠ هذه المسابقة المØدودة عبث لأنه مادام ÙØªÙˆØ Ù…ÙˆØ¬ÙˆØ¯Ø§ لن يشارك Ø£Øد آخر. كان مطلع قصيدتي:
هل قضى Ù†Øبه وهل صار ذكرى * وطواه الردى Ùقصّر عمرا
كي٠يندك شامخ متأبّ * عصرته الأØداث والدهر عصرا
ودهته Ùما ألان قناة * لعتي أراد للعود كسرا
ÙˆÙيها:
إن يكن ضمه بأسوان قبْر * صار يزهى على المقابر Ùخرا
Ùهو بين العقول ÙŠÙ†Ø¯Ø§Ø Ùكرًا * وهو بين القلوب ينبض ذكرى
يا رÙبى الخلد كبري Øين يأتي * واÙتØÙŠ من Øنانك الغض صدرا
وامنØيه تØية منك طرسًا * وأعدي له يراعًا ÙˆØبرا
علّه من علاك يزجي بيانًا * كاشÙًا عن غوامض الØÙ‚ سترا
كاشÙًا ساØرا به كل Ø£Ùعى * ظنت الموت يبطل اليوم سØرا
ÙاستÙاقت من بعده تتباهى * وتلوّت لتنÙØ« السمّ ÙƒÙرا
ولنا الله بعد يتم يراع٠* صال Øرا واليوم يغمد Øرا
وله جنة الخلود جزاء * ولتعادلْه جنة الخلد أجرا
وصدق Øدس Øامد، Ùلم يلق Ø£Øد شعرا سوى Ù…Øمد ÙتوØØŒ وقد أصابني هذا بشيء من الإØباط.
كان من المعيدين الذين Ø£Øاطونا بكثير من الرعاية والعط٠والتشجيع علي عشري زايد – عليه رØمة الله – Ùقد كان لا يقصر اهتمامه على الندوة الأسبوعية التي تقام كل يوم خميس، بل كان إذا أسمعه Ø£Øدنا قصيدة استكتبه إياها وأخذ نسخة منها، ويعود بعد أيام قليلة وقد كتب عنها أكثر من ملزمة ويعيدها مع ما كتب، ولو جمع ما كتبه عن قصائد الطلاب لكان أكثر من ثلاثة مجلدات ضخام. ÙŠÙعل هذا مبعوثا إليه Ø¨Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ù…ÙˆØ¯Ø© والتعاطÙØŒ والØØ« والأخذ بأيدي الصغار ÙÙŠ غير Ù…ÙŽÙ†ÙÙ‘ ولا أذى.
وكان منهم سعد Ù…ØµÙ„ÙˆØ ÙˆÙ‡Ùˆ شاعر ذو شعر رصين، وكانت سÙÙ†Ùّه – وقد تخرج ÙÙŠ الصي٠الذي دخلنا Ùيه الكلية – مقاربة لسÙنّنا، بل أنا أكبره بعامين، وكان هذا مبعث إعجابي الشديد. لقد خلطنا بنÙسه، وآخانا مؤاخاة Øميمة، وكان ينشدنا من مختاراته أكثر مما ينشدنا من شعره، وقد شكلت رؤيته الناضجة ÙˆÙهمه للشعر جزءًا كبيرًا من رؤيتنا.
وكان منهم Ù…Øمد عيد الذي كان يتمتع بجدية صارمة، وكانت نظرته إلى أستاذ الجامعة أقرب إلى التقديس منها إلى شيء آخر، يراه صاØب رسالة من الرسالات الكبرى، وكان يأخذ Ù†Ùسه قبل غيره بهذه الرؤية، ويØاول أن ÙŠØمل الآخرين على ما يرى، ويأخذهم به، ويريدهم عليه. كان يشارك ÙÙŠ الندوات ويزن كلامه بميزان دقيق، ولكنه إذا أعجب بإØدى القصائد ظل يردد الØديث عنها زمنا طويلا يبادر به صاØبها وإن لم تدع إلى ذلك مناسبة.
وكان منهم Ù…Øمد أبو الأنوار الذي كان يشارك قليلا ÙÙŠ التعليق على الندوات، ولكن اتجاهه كان أقرب إلى المعايير القديمة، على عكس Ù…Øمد ÙØªÙˆØ Ø§Ù„Ø°ÙŠ ينشد الأÙكار الجديدة.
وكانت Ø£Øكامه – أي Ù…Øمد أبو الأنوار – قاطعة Øاسمة. وكان يق٠عند اللÙظة الواØدة ينشد أناقتها ودقتها من وجهة نظرة، وتمثلت لنا ملاØظاته على هيئته واضØØ© Ù…Øددة أنيقة Øسنة المظهر.
وكان منهم Øسن الشاÙعي الذي بدا لنا ÙÙŠ Ùكره وأسلوبه وطريقة تعامله أكبر من معيد، لم تكن ملاØظاته جزئية، وكان ذوقه ناÙذا، وكان أشبه بالقائد المØنك الرØيم، وكان يدرس لنا Ø£Øد كتب الدكتور Ù…Øمود قاسم عميد الكلية وقتها، وكان يهتم بأØسن ما لدى كل منا ويغضى عن هناته، وإذا أشار إلى شيء من هذه الهنات Ùمع ابتسامة Øانية تجعل تقبل الملاØظة سائغا. لم يكن يعلق على الندوات بل كان تعليقه دائمًا ÙÙŠ جلسات خاصة ÙÙŠ الكلية أو ÙÙŠ بيته الذي كان يساكنه Ùيه علي عشري.
وقد قربنا هؤلاء جميعا منهم كأننا معيدون بينهم، وبعضهم كان يزورني ÙÙŠ بيتي. وقد كانت آراؤهم ومناقشاتهم ذات أثر كبير ÙÙŠ تصØÙŠØ Ù…Ùهومنا وتعديل Ø£Ùكارنا وتشكيل رؤانا، على اختلا٠بينهم ÙÙŠ التأثير، وعلى تÙاوت ÙÙŠ القرب والبعد. بدت لنا الكلية كلها Øركة نشطة من الثقاÙØ© والÙكر، وكان أظهر نشاطها هو الشعر والنظر Ùيه، Ùكأن الكلية كلها تتنÙس شعرًا.
ÙÙŠ الصي٠لم أذهب إلى قريتي ككل صي٠سابق، Ùقد Øصلت على عمل ÙÙŠ القاهرة، وهو العمل Ù†Ùسه الذي Øصل عليه Ø£Øمد درويش، ولذلك اتصل لقاؤنا، وتكرر كثيرا. ÙÙŠ Ø£Øد لقاءاتنا قال Øامد: يجب أن تكون لنا مقررية جماعة الشعر، واختارني لهذه المهمة، واعتذرت، وقبلها Ø£Øمد، وبتدبير ذكيّ من Øامد Ù†ÙØ° ما أراد ÙÙŠ أول العام الدراسي، ÙØ£ØµØ¨Ø Ø§Ù„ØªØ®Ø·ÙŠØ· لجماعة الشعر ونشاطها بأيدينا، وقد زاد من اØترام زملائنا ÙˆØÙاوة المعيدين وبعض أساتذتنا بنا أننا كنا من الأوائل. وقد انضم إلينا عدد من الأصدقاء الذين كانوا يكتبون الشعر مثل عبد الرØمن سالم والسعيد شوارب.
وقام صديقنا Øسن البنداري بتألي٠(جماعة القصة) التي توازت مع جماعة الشعر، وكانت تعقد ندوتها عقب دروس يوم الاثنين مع كل أسبوع وتعاون معه عدد من الزملاء ÙƒÙتَّاب القصة القصيرة مثل رÙعت الÙرنواني – عليه رØمة الله – ومØمود عوض عبد العال، وعبد الÙØªØ§Ø Ù…Ù†ØµÙˆØ± الذي كان قصاصا واعدًا ولا أدري كي٠تصرÙت به الأيام، وأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة علي أبو المكارم ثم عبد الØكيم Øسان. وأصبØت الكلية شعلة من النشاط الثقاÙÙŠ Øيث الندوات والمهرجانات التي كثر عددها ÙÙŠ العام وكان هناك من قبل مهرجان واØد كل عام، وتردد على الكلية الشعراء الكبار وشعراء جيل الوسط، وكان أبرز الشعراء الذين ينشدون ÙÙŠ المهرجان نزار قباني ÙˆØµÙ„Ø§Ø Ø¹Ø¨Ø¯ الصبور وأØمد عبد المعطي Øجازي ومØمد الÙيتوري ÙˆÙاروق شوشة وإسماعيل الصيÙÙŠ وأنس داود ومØمد ÙتوØ. وألقى الشعراء من الطلاب أشعارهم أمام هؤلاء. وكان عميد الكلية الدكتور Ù…Øمود قاسم علي رأس Ù„Ùي٠من الأساتذة ÙÙŠ مقدمة الØضور ÙÙŠ كل مهرجان، وكان العميد دائمًا يلقي كلمة ترØيب بضيو٠الكلية من الشعراء. وكنت أرى الØركة إلى الكلية ومنها ÙÙŠ هذه المناسبات كما وصÙها العقاد أشبه بخط النمل وكان Ù…Ø³Ø±Ø Ø§Ù„ÙƒÙ„ÙŠØ© يغص بالرواد. وكان شعراء الكلية يستعدون للمهرجان استعدادا خاصا بأن يقدم كل منهم قصيدة جديدة لم ينشدها من قبل ÙÙŠ الندوة أو غيرها، وكان Ø£Øمد درويش كثيرا ما يتألق ÙÙŠ تقديم الشعراء الكبار والصغار، وكنا Ù†ØÙ† نختار القصائد التي تستØÙ‚ أن تلقى ÙÙŠ المهرجان.
ÙÙŠ هذه الÙترة كانت مصر كلها ÙÙŠ ذروة تألقها الثقاÙÙŠØŒ Ùكانت هناك مجلة للشعر، وأخرى للقصة، وثالثة للمسرØØŒ ورابعة للسينما، وخامسة للكتاب، وسابعة لتلخيص أمهات الكتب العربية والعالمية تØت اسم (تراث الإنسان)ØŒ بالإضاÙØ© إلى مجلة (المجلة) Ùˆ(الرسالة) Ùˆ(الثقاÙØ©) Ùˆ(عالم الÙكر) ØŒ ومع هذا كله إصدارات أسبوعية ونص٠شهرية وشهرية لأنواع من الكتب كأعلام العرب ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³Ø±Ø Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠ والروايات والمكتبة الثقاÙية وروائع المسرØØŒ ويواكب هذا أيضًا إصدار جديد لأمهات التراث العربي كالأغاني للأصÙهاني وعيون الأخبار لابن قتيبة ÙˆØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø£Ø¹Ø´Ù‰ للقلقشندي والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردي، ونهاية الأرب للنويري، وكانت أثمان هذه الكتب والمطبوعات ÙÙŠ متناول الجميع. كان المد القومي قبل هزيمة يونيه والشعور الوطني ÙÙŠ ذروته، وكان هناك تجاوب ÙÙŠ كل مناشط الØياة مع هذا الشعور الطاغي.
ÙÙŠ هذه المرØلة كتبت قصيدة الشعر الØر، وعرÙت قصائدي طريقها إلى مجلة الشعر التي كان يرأس تØريرها الدكتور عبد القادر القط الذي لم يكن الوسيط بيني وبينه إلاّ ساعي البريد، وكنت أوقّع القصيدة باسمي Ùقط دون أية بيانات أخرى. كان كل منا مع الصلة الشديدة يسلك سبيله ÙˆØده ÙÙŠ نشر قصائده، ولا يتØدث مع الآخريْن ÙÙŠ شيء من هذا، ويسعد بمÙاجأة زميليه بنشر قصيدة له، وكذلك كنا Ù†Ùعل ÙÙŠ التقديم لجوائز الشعر، وكنا Ù†Ùاجأ بوجودنا معا ÙÙŠ تسلم الجوائز التي كنا نتبادل Ùيها المواقع الأولى، وقد Ù„Ùت هذا نظر يوس٠السباعي مرة Øين صعدنا أكثر من مرة لتسلم الجوائز Ùقال: (إنكم سو٠تقضون على كل الجوائز) .
كان نجاØÙŠ بامتياز ÙÙŠ سنوات الدراسة يعزز موقÙÙŠ الشعري بشكل ما، وكنا معا مرموقين متألقين، وكل منا يتألق ÙÙŠ جانب، وكان Øامد أكثرنا تألقا ÙÙŠ الشعر، وأغزر إنتاجا وتنوعا ÙÙŠ قصائده.
ÙÙŠ هذا العام عاد إلى الكلية بعض المبعوثين الذين Øصلوا على الدكتوراه من لندن وكامبردج وهم السعيد بدوي ومØمود الربيعي ÙˆØمدي السكوت وكمال جعÙر (يرØمه الله) وأØمد غراب (يرØمه الله) وعلى Øبيبة، وقد درسوا لنا جميعا إلا السعيد بدوي الذي أشعر أن من نعمة الله علىّ أنْ Ø³Ù…Ø Ù„ÙŠ Ùيما بعد بأن أكون قريبا منه.
وقد قلت ÙÙŠ إهدائه كتابا لي:
ليس من نال ÙÙŠ الخلائق جاهًا * أو Øوى المال كيسه بالسعيد
السعيد السعيد من خصه الله٠بÙضل Ùنال ودّ (السعيد).
وقد Ø£Øسسنا Ù†ØÙ† – الطلاب – بأثر هؤلاء ÙÙŠ الكلية على تÙاوت بالطبع بينهم، وكان عميد الكلية يميل إلى الشباب ويثق بهم ويØثهم على الالتصاق بالطلاب ÙÙŠ المناشط الثقاÙية. وكنا نسمع عن Ù…Øمود الربيعي، وقد قرأنا له قصيدة ÙÙŠ مجلة دار العلوم ÙÙŠ سنوات الخمسينيات مطلعها:
أنا عائد من قريتي * ÙÙŠ الري٠أØكي قصتي
وأعجبنا بها، وكان ÙŠØدثنا عنه Ù…Øمد ÙتوØØŒ ويقول: سو٠يجيء إليكم شاعر ناقد من طراز Ùريد. وقد كتب ÙØªÙˆØ Ù‚ØµÙŠØ¯Ø© جميلة ÙÙŠ استقبال هؤلاء العائدين بعنوان (أمّي الثانية). سرعان ما جذبنا Ù…Øمود الربيعي بسلوكه الراقي، وأدائه المتميز، وثقته الكبيرة بالنÙس، وتطلعه إلى مساعدة الشباب والأخذ بأيديهم. وكما اصطÙانا السيد صقر ÙÙŠ معهد القاهرة الديني اصطÙانا Ù…Øمود الربيعي ÙÙŠ دار العلوم، ووجدنا Ùيه أستاذا مستنيرا وأخا أكبر وصديقا Øميما، وكان أكثر ما Ù„Ùتنا Ùيه أول الأمر تعليقه النقدي الذي يص٠Ùيه القصيدة ويØاول أن ÙŠÙسّر دون أن يصدر Øكما بالجودة أو بالرداءة ولم يمض وقت طويل Øتى كنا من Ù…Øبيه ÙˆØوارييه، وقد Ø£Ùدنا Ø¥Ùادة كبيرة من رؤيته النقدية، وبعض نظراته ÙÙŠ الØياة والناس، وترى هذا مصدÙّقا ÙÙŠ مقدمته الضاÙية التي كتبها لمجموعتنا المشتركة الثانية (ناÙذة ÙÙŠ جدار الصمت).
ÙÙŠ هذه المرØلة دعينا Ù†ØÙ† الثلاثة لأمسية شعرية لا يشاركنا Ùيها شاعر آخر ÙÙŠ المركز العام للشبان المسلمين، ذلك المكان الذي كنا نتردد عليه ÙÙŠ المرØلة الثانوية وتتطلع Ù†Ùوسنا إلى الإنشاد على منصته، وكان هذا أمنية يتمناها لنا المØبون، وكان ÙÙŠ هذه الأمسية أستاذ من دار العلوم يقوم بالتعليق النقدي على القصائد التي سنلقيها. ولما ألقينا قصائدنا تقدم هو للتعليق، وكنا نجلس خلÙه، وسمعته يقول كلامًا لا علاقة له بقصيدتي، Ùهمست Ù„Øامد – أو ظننت أنني أهمس – قائلا: (إنه لا ÙŠÙهم القصيدة). وكانت المÙاجأة التي أصابتني بكثير من الخجل أنه سمع عبارتي، وعلق عليها بصوت مسموع للجمهور مما زادني خجلا. والغريب أنه لم يغÙر لي هذه العبارة Øتى يومنا هذا، وكانت Ø£Øد الأسباب ÙÙŠ الكثير مما عانيته منه بعد ذلك.
ÙÙŠ آخر سنة لنا بالكلية، وعقب Ø£Øد المهرجانات الشعرية، انÙرد بنا ØµÙ„Ø§Ø Ø¹Ø¨Ø¯ الصبور – وكان وقتها يرأس الهيئة العامة للكتاب – وطلب منا أن يعد كل منا عددا من القصائد ليطبعها لنا ÙÙŠ ديوان واØد، وسعدنا بهذا الطلب وأسرعنا ÙÙŠ إعداد ما طلب منا، وذهبنا إلى مكتبه ÙÙŠ الهيئة العامة للكتاب واستقبلنا استقبالا ودودًا، وسلمناه قصائدنا مجموعة معا، وسمينا هذه المجموعة (ثلاثة ألØان مصرية)ØŒ وقد تلكأتْ بتأثير الروتين المصري ثلاث سنوات، Ùلم تظهر إلا سنة 1970ØŒ وتناول كل منا عن هذه المجموعة أربعين جنيها، اقتطعت الضرائب منها خمسة جنيهات، ولكني Ùوجئت ÙÙŠ السنة التالية بخطاب من الضرائب يطالبني بضع٠ما أخذته عن هذه المجموعة تØت عنوان أن مهنتي (مؤل٠أشعار)!
راقت لنا Ùكرة إخراج شعرنا ÙÙŠ ديوان مشترك، واتÙقنا على أن نلتزم بهذا النهج، ولكننا لم ننÙذه إلا مرة واØدة بعد ذلك سنة 1975 عندما أخرجنا الديوان المشترك الثاني (ناÙذة ÙÙŠ جدار الصمت) الذي كتب مقدمته الدكتور Ù…Øمود الربيعي، وكان Ø£Øمد ÙˆØامد قد ساÙرا مبعوثين إلى Ùرنسا، وأشرÙت أنا على تنÙيذه. Ùاجأنا Øامد سنة 1984 بإخراج شعره ÙÙŠ (ديوان Øامد طاهر) وكان يتضمن ما نشر من قبل ÙÙŠ (ثلاثة ألØان مصرية) Ùˆ(ناÙذة ÙÙŠ جدار الصمت) Ùكان هذا إعلانًا بالتخلي عن الاتÙاق السابق، تØمسنا بعد ذلك ÙÙŠ سنة 2001 ÙÙŠ جلسة غداء جمعتنا لتكرار التجربة، ولكن الÙكرة تبخرت بانتهاء الجلسة Ù†Ùسها وكأنها طائ٠عابر من الØنين إلى الماضي.
كانت سنوات الدراسة بالكلية هي Ùترة التوهج الشعري، والأمل، والتطلع إلى المستقبل، والتÙاؤل، والÙوران العاطÙÙŠØŒ وكان الجو العام كله مستجيبا لهذا التوهج على المستوى الوطني والقومي Øتى Ùاجأتنا هزيمة يونيه المنكرة بما جرّته من Ø¥Øباط وشعور بالخزي والعار.
وكان يوم 5 يونيه من أيام أداء امتØان الليسانس، Ùتعطلت الامتØانات، وكأن الØياة Ù†Ùسها توØÙŠ بالتوقÙØŒ وكان Øامد يقضي معي معظم الوقت، ورأينا أنÙسنا معا نبدأ قصيدة تجمع بين السخرية والØسرة، كان Øامد يبدأ بشطر وأكمل الشطر الثاني أو العكس.
تخرجنا ÙÙŠ هذا العام بامتياز مع مرتبة الشر٠الأولى، وعينا معيدين كل ÙÙŠ قسم مختل٠عن الآخر، واخترت قسم النØÙˆ والصر٠والعروض، وظننت أن الشعر سو٠يبتعد عني، ولكنه ظل مني قريبًا، يخايل Ø£Øيانا دون أن يتمكن مني، ÙˆÙŠÙ„Ø Ø£Øيانا Ùلا ÙŠÙصم عني إلا بقصيدة. وكنت وما زلت أسعد بالقصيدة أكتبها، وأØس أني بكتابتها قد أسهمت ÙÙŠ صياغة العالم من جديد، وأعتقد أن هذا الشعور الجميل هو المكاÙأة التي يتلقاها الشاعر على كتابة القصيدة، وقد كنا ثلاثتنا Ù†Øسّ أن الدنيا تجدد Ù†Ùسها عندما يكتب Ø£Øدنا قصيدة، وإذا قال Ø£Øدنا قصيدة كان الآخران جمهوره وناقديه، ومن هنا قويت العلاقة ÙˆØدث ما يشبه الاستغناء عن الآخرين، ÙˆØ£ØµØ¨Ø (الثلاثي) مقصورا على Ù†Ùسه أو يكاد.
وظل الشعر بيننا زمنا طويلاً صلة قائمة مقام الوالد على Øد تعبير أبي تمام:
أو يختلÙÙ’ نسبٌ يؤل٠بينَنا * أدبٌ أقمناه مقام الوالد
نجتمع Øوله، ونناقش أمره، ونتكاتب به Ø£Øيانا. عندما عاد Øامد من بعثته ÙÙŠ Ùرنسا سنة 1981 كنت ÙÙŠ الكويت Ùكتبت له قصيدة موجهة إلى ابنته (دينا) مطلعها:
ردّي علينا إذا Øييت يا دينا * إنا اتخذنا هواكم ÙÙŠ الهوى دينا
ÙˆÙيها:
سلي أباك Ùقد كانت أعنتنا * ÙÙŠ ÙƒÙÙ‡ وهو أنّي شاء Øادينا
كنا ثلاثة أتراب يراودنا * للنور شوقٌ ومنه كان هادينا
Ùكان من أنسه رَوْØÙŒ يراوØنا * وكان من رÙÙˆØÙ‡ شعرٌ يغادينا
وكان إمّا اÙترقنا نبض مهجتنا * وكان إمّا التقينا قلب نادينا
وكم سعدنا به والدهر يجمعنا * وكم به ÙƒÙبتتْ غيظا أعادينا
وكم تعبنا ولم يظÙر بنا تعبٌ * ما غيرته عن الØسنى عوادينا
ويكتب Ø£Øمد درويش من Ùرنسا أنه اشترى سيارة (تاونس) Ùأهنئه بها قائلا:
أبا هشام وإني * Ù…Øضتك الودّ Ù…Øْضا
منّي إليك تهان * رأيتها لك Ùرضا
بتَوْنس٠ÙÙŠ سراها * تكاد تترك الارضا
وتمتطي Ø§Ù„Ø±ÙŠØ Ø³Ø¨Øًا * إن شئت طولاً وعرضا
ولا تشكَّى اهتزازًا * ÙÙŠ السير عÙلْوًا وخÙضا
وأنت Ùيها مليكٌ * تشير Ùالأمر ÙŠÙقْضى
من Øولك الزÙّهْر تلهو * والبعض يتبع بعضا
(رشا) تثير (هشامًا) * لعلّ (غادة) ترضى
ÙÙŠÙستثار (هشامÙ) * ويقلب الأمر Ùوضى
Ùإن نظرت إليه * رنا Øياء وأغضى
Ùدمتَ Ùيهم وداموا * ÙÙŠ نعمة ليس تÙنْضى
ÙÙŠ ظل بيت٠دÙيء * يرقرق الØبّ غضا
أبا هشام وإن الØياة تسرع ركضا
مرني وأنت مطاع * بما تشاء وترضى
هذي Øقوق وإنّ الØقوق عندىَ تقضى
أقدم Ø§Ù„Ø±ÙˆØ Ø²Ù„ÙÙ‰ * والمال إن شئت قرضا
ومن اللطي٠أن Ø£Øمد لم يعلق من القصيدة كلها إلا على الشطر الأخير منها (والمال – إن شئت – قرضا) معترضا على أن يكون المال (قرضا)!
وظل الشعر وسيلتنا طيلة Ùترة الشباب لنقد بعض الأوضاع التي لا تعجبنا، وقد كتبنا كثيرًا من القصائد الساخرة نشترك ÙÙŠ كتابتها، وتتقاÙز بيننا الأبيات والأشطر، وقد اØتÙظ Øامد بمعظم هذا الشعر، وكان Øامد يتميز بقدرته الساØرة ÙÙŠ تصوير من يصورهم ÙÙŠ شكل كاريكاتوري ساخر، وبقدرته على اقتناص أهم الصÙات المميزة للشخص المصور، ولذلك لم يكن غريبًا عليه أن ينÙرد بعدد من قصائد هذا النوع، وأن يؤل٠Ùيما بعد ديوانًا كاملاً بعنوان (ديوان النباØÙŠ) وهو ديوان شعر متخيل ينتقد Ùيه كثيرًا من الأوضاع والصÙات والأشخاص. وهذا نموذج من هذا اللون من الشعر الساخر، Ùقد كتبنا معًا قصيدة عن (الرّصد) – وهو Ø£Øد أهم أعمال الامتØانات – عارضنا بها قصيدة طرÙØ© بن العبد التي مطلعها:
أصØوت اليوم أم شاقتك هر * ومن الØب جنون مستعر
نقول Ùيها إن لم تخني الذاكرة:
أرصدت اليوم أم شاقتك هر * ومن الرصد جنون مستعر
عَصْلجَ المÙØªØ§Ø ÙÙŠ الباب Ùلم * يتØرك والتوى ثم انØشر
Ùأتى النجار ÙÙŠ كوكبة٠* من شواكيش وأشياء Ø£Ùخَرْ
ومضى يبذل Ùيه جهده * ثم لما لم يلن معْه انكسر
Ùدخلنا كأسود جوعت * ثم ألÙتْ Ùجأة سرب بقر
كل ك٠تهبش الكش٠Ùإن * شدّ زيد Ù†Øوه ØµØ§Ø Ø¹Ù…Ø±Ù’
وطلبنا أل٠ليمون Ùلم * يعصر الليمون والعمر انعصَرْ
وسعى كل مريد نمرة * سعى ثعبان إلى البيض Øذر
Ùإذا أبصرها ناجØØ© * أطلق الساقين Ù„Ù„Ø±ÙŠØ ÙˆÙر
وإذا ما ظهرت راسبة * قطب الوجه Øزينا واكÙهر
وإذا لم يتمكن منهما * لعن الإخوان سرا وانتظر
يا رÙاق الرَّصد من عهد الأولى * رصدوا النجم وعاشوا ÙÙŠ الØÙر
لا تلوموا عاشقا ÙÙŠ رصده * إنما الرصد قضاء وقدرْ
ولقد صور Øامد هذه المرØلة ÙÙŠ قصيدة من أجمل قصائد شعره بعث بها إلىّ من Ùرنسا وهي ÙÙŠ ديوانه بعنوان (ثلاثة أصدقاء وقمر) يقول ÙÙŠ مطلعها:
كنا ثلاثة أصدقاء
ÙÙŠ Ø§Ù„ØµØ¨Ø ÙŠØ¬Ù…Ø¹Ù†Ø§ لقاء
ومع المساءْ
قمر وأغنية شريده
وقد سعدت بالقصيدة جدا، ولكن لا أدري لماذا انقبضت Ù†Ùسي من بدئها بـ (كنّا) الدالة على المضيّ، وتمنيت لو أنه قال: (إنّا). غير أن التعبير الشعري الصادق أدلّ على Ø³ÙˆØ§Ù†Ø Ø§Ù„Ù†Ùس من سواه.
وقد ظلت هذه العلاقة قوية ما كان هناك شعر يقال، وما كانت هناك رغبة ÙÙŠ صديق يسمع، Ùهذه علاقة قامت من أول أمرها على الشعر وظلت عليه، ولم تطور Ù†Ùسها ÙÙŠ غيره، Ùلما باعدت بينا الإعارات، وجرى المال ÙÙŠ أيدينا، واختلÙت الأهواء وخÙت صوت الشعر؛ تقطعت الأسباب، ولم يبق إلا ذماء واهن يربطها بذكريات عهد الشباب الخصيب.
كنت أتمنى أن ÙŠØب أولادي الشعر وأن يكتبوه، Øاوله ولدايَ Øاتم وأشرÙ. Øاوله Øاتم وهو Ø·ÙÙ„ وكتب أشياء أقَمْتها له. ÙˆØاوله أشر٠شابا، ولكنه لم يشركني ÙÙŠ كثير مما كتب، ولكن Ù…Øاولاته اÙتقدت أهم مقومات الشعر وهو الوزن. ÙˆØاولته ابنتاي مي ونورا، وكانت نورا أقرب إلى تØقيق شيء ÙÙŠ هذا الطريق لولا أنها شغلت بدراسة الطب.
قالت لي مي يومًا – شأن كل بنت – أنت أعظم رجل، وأنت أكثر الرجال وجاهة، Ùقلت لها أبياتًا ما تزال تØتÙظ بها ÙÙŠ اعتزاز، وهي:
تقول ميّ وكادتْ * تطير عÙجْبَا وتيها
أبي أراك عظيما * ÙˆÙÙŠ الرجال وجيها
Ùقلت والØÙ‚ عندي * خليقة أبديها
يا ميّ كل Ùتاة٠* Ù…Ùتونة بأبيها
دÙعني Øب الشعر من Øيث لا أدري إلى إخضاع تخصصي العلمي لبعض مطالبه، Ùأنجزت رسالتي الجامعية الأولى عن الضرورة الشعرية، وكتبت Ùصلاً من رسالتي الجامعية الثانية عنه، وعقدت Ùصلاً عن بناء الجملة ÙÙŠ الشعر القديم ÙÙŠ أول كتبي بعد ذلك، وكتبت كتابًا عن الجملة ÙÙŠ الشعر العربي، وكتابًا عن اللغة وبناء الشعر، وكتابًا عن الإبداع الموازي: التØليل النصي للشعر، وكتابًا عن الظواهر النØوية ÙÙŠ الشعر الØر، وعددًا من الأبØاث المختلÙØ© تتناول بعض الظواهر Ùيه. وكان الاشتغال بالشعر يشبع شيئًا من الشوق القديم الكامن إلى كتابته، ولكن كتابة الشعر شيء والكتابة عن الشعر شيء آخر.
وتراودني بين الØين والآخر تلك الرغبة الملØØ© ÙÙŠ كتابة قصيدة، كثيرًا ما لا تكتمل، وقليلا ما تكتمل. ويظل التعلق بأهداب الشعر سرابًا يشدني وأصدّقه Øتى إذا جئته لم أجده شيئًا.
أراني اليوم وقد أكملت الثالثة والستين من العمر أشعر بالخجل إذا عدّني Ø£Øد من الشعراء، وأشعر بالØزن والأسى إذا لم أعد منهم. وسواء عددت من الشعراء أو لم أعد منهم Ùإنني على صلة بالشعر، أقرؤه، وأØاوله، وأستمتع بقراءته، وأستمتع بمØاولته، وكلما تقدمت بي السن أجدني مشدودًا إلى الشعر القديم أتأمله وأتطعم بناءه، وأجد أننا لم نعطه Øقه، ولم ندرك كل أسراره، كما أجدني إذا Øاولت شيئًا منه مبتعدًا عن الشعر الØر، مائلاً إلى الكلام الموزون المقÙى، وأجدني أعدل عن الأبØر الشائعة المطروقة إلى الأبØر غير الشائعة، وأجدني Ø£Øب القاÙية الواضØØ© الجلية غير الذلول ÙˆØبذا لو كان بها لزوم ما لا يلزم Øتى تكون أكثر وضوØًا وجلاء، وأØس الآن أن العبقرية ÙÙŠ الÙÙ† تكمن ÙÙŠ الإبداع من خلال القواعد لا تØطيمها، ومن هنا انصرÙت Ù†Ùسي عما يسمى (قصيدة النثر) وأرى أن التسمية ساعدت على الانصرا٠عنها، ÙأصØابها يريدوننا على أن نتجرع شيئًا لا صلة له بما ألÙنا أنه شعر على أنه شعر. ويذكرني هذا بموق٠ÙÙŠ Ùيلم (طاقية الإخÙاء) إذ ÙŠÙخرج الممثل القدير توÙيق الدقن علبة كبريت ويسأل الممثل عبد المنعم إبراهيم عما ÙÙŠ العلبة، ويرغمه على أن يقول إن الذي Ùيها Ùيل. هذا Øال أصØاب قصيدة النثر معنا، يريدون أن يرغمونا على أن هذا شعر. إن جزءا من تذوق أي عمل Ùني معرÙØ© قالبه، ومطابقة هذا القالب ولو جزئيًا لما هو Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø¹Ù„ÙŠÙ‡ ÙÙŠ تاريخه. ولو Ù†Ø¬Ø Ù‡Ø¤Ù„Ø§Ø¡ ÙÙŠ تسمية Ùنهم تسمية مستقلة على أنه ضرب جديد من ضروب الÙÙ† القولي لربما كان ذلك أدعى لقبوله وتذوقه.
كنت – وأنا شاب صغير – أسمع القصيدة Ùيعتريني عند جزء منها ما يشبه القشعريرة تسري ÙÙŠ جسمي كله، Ùأدرك من Ùوري منها أن هذه قصيدة جيدة، وكنت أسمع القصيدة ÙتØملني بعض صورها إلى واد٠غريب، وتÙجر بعض جملها دلالات جديدة ÙÙŠ Ù†Ùسي، Ùأدرك أن هذه قصيدة جيدة. وكنت أسمع القصيدة Ùلا يعتريني شيء من هذا ولا ذاك، Ùأتهم Ù†Ùسي بأني لم Ø£Øسن استقبالها، وأعود إليها، Ùإذا بي Ø£Øسّ ÙØسب أنها قعقعة لغوية وطنين أوزان Ùتنصر٠عنها Ù†Ùسي وأنا أرثي لصاØبها، وكثيرًا ما أرثي لأولئك الذين يتمسØون بالشعر ولا ÙŠØققون منه شيئًا، ويتأكد لديَّ يومًا بعد يوم أن (الشعر صعب وطويل سلّمه).